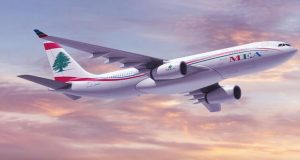مجلة وفاء wafaamagazine
مرّ يوم البيئة العالمي، في الخامس من حزيران، هذا العام وكأنه لم يكن. أزماتنا المتعددة والمتشابكة، وحال الانهيار الشامل، أكلت الأخضر واليابس فعلاً. وحده وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، دميانوس قطار، الصامت عن معظم المشكلات والملفات التي واجهتها البيئة في «عهده»، تذكّر المناسبة ببيان شكلي.
الأمر نفسه انسحب على الجمعيات وتجمّعات الجمعيات، الكبيرة منها والصغيرة، والحركات البيئية، والرسوم المتحركة فيها. إذ لم تنتبه إلى هذه المناسبة، لانشغالها في كيفية صرف مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمشروع سخيف حول البلاستيك، بما أن التعطّش إلى العملات الصعبة بات أهم من العطش إلى الماء.
العالم، أيضاً، بدا بعيداً عن إحياء هذا اليوم. لم تخرج الأمم المتحدة التي حددت هذا اليوم عام 1974 عن «تقليد» الرثاء السنوي على حالة الأرض، ولم تملّ من ترداد أسطوانة أن هذا اليوم هو للتوعية على المخاطر والتحديات التي تهدد البيئة العالمية. فيما كتّاب تقاريرها يعانون من انفصام إذ يفصلون بين «حياة» تقاريرهم وحياة الكوكب، ويصمّون آذانهم عن دعوات مفكري البيئة بدمج تقاريرهم العلمية السنوية بخبرات فلسفية واجتماعية ونفسية، تحلل العقليات المسبّبة للكوارث البيئية وتترصّدها كما تترصّد حياة الأنواع.
وقد كان شعار الأمم المتحدة هذا العام باهتاً وأكثر شكلية من بيان وزارة البيئة اللبنانية. برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أحيا اليوم تحت عنوان «استعادة النظام الإيكولوجي». صحيح أن الهدف نبيل، إلا أن الجميع يعلم أن استعادة النظم باتت مستحيلة في ظل موجات انقراض الأنواع في أقل تقدير، وفي ظل اعتماد نظام حضاري عالمي يمجّد مفهوم «التنمية»، بما تعنيه من زيادة مفرطة في الإنتاج والاستهلاك. وإذ لم تجرؤ تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة على نقد النماذج الحضارية المسيطرة، تكتفي – كما في كل عام – بدعوة الحكومات للالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أُبرمت غالبيتها منذ أكثر من ربع قرن ولم تُحترم.
تعرف الدول أن تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل حماية التنوّع البيولوجي والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (أُبرمت في قمة ريو عام 1992) كان يمكن أن تساهم، وحدها، في استعادة النظم الإيكولوجية المتعددة حول العالم، والتي كانت تتطلّب التخفيف من مستوى التلوث والضغوطات المتزايدة على النظام البيئي من خلال الاستثمارات المتعددة الأشكال والمستنزفة للموارد. كما بات العالم يعرف أن الحفاظ على التنوع البيولوجي لا يقوم فقط على «زيادة عدد المحميات الطبيعية وحماية الغابات والتشجيع على إعادة تحريج المناطق المتضررة». وحده معدّ التقرير الإعلامي لوزارة البيئة في لبنان هذا العام، أعلن – مبتهجاً – أن عدد المحميات الطبيعية في لبنان خلال عام 2020 زاد من 15 الى 18 بعد إقرار مجلس النواب قوانين إنشاء ثلاث محميات طبيعية جديدة، بناءً على اقتراح وزارة البيئة، وهي محميات جبل حرمون الطبيعية (جبل الشيخ) في قضاء راشيا، ومحمية شاطئ العباسية الطبيعية في قضاء صور، ومحمية النميرية الطبيعية في قضاء النبطية. واعتبر أن هذه المحميات، إضافة إلى المواقع المصنّفة طبيعية (عددها 19)، «من أهم الوسائل الوقائية التي تلعب دوراً مهماً في حماية الموارد الطبيعية وموائل لعدد كبير من النباتات والحيوانات البرية والطيور المتنوعة والفريدة، كما أنها تُعتبر من الركائز الأساسية في سياسة التنمية الريفية والسياحة البيئيّة في لبنان بما يعود بالفائدة والمردود الاقتصادي على المجتمعات المحلية». إلا أن بيان وزارة البيئة لم يذكر كيف ولماذا تعثّرت الوزارة في حماية المحميات والمناطق المصنّفة طبيعية أولاً، وفي حماية بقية المناطق اللبنانية، مع العلم أن المناطق المحمية لا تشكل سوى 2 أو 3% من مساحة لبنان، وأن حجم التشويه والتدمير العشوائي من جراء أعمال قطاعات مثل المقالع والكسارات والمرامل، التي كان على وزارة البيئة أن تنظمها، يكاد يقارب حجم مساحة المحميات! إضافة إلى التراخي والفشل في إلزام المشاريع الكبرى بإجراء التقييم البيئي الاستراتيجي لها، وكان آخر هذا التراخي عدم تقييم مشروع توسيع طريق وادي الجماجم (بالاستثمار بالمقالع والكسارات)، المصنّف موقعاً طبيعياً ذا امتداد إيكولوجي على جبل مهم مثل جبل صنين! ناهيك بتهريب قرار السماح بالصيد البري الذي يسمح بقتل الطيور التي تُعتبر صمام الأمان الأول لحماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البرية. وقد شهد لبنان أخيراً تكاثراً غير اعتيادي لدودة «جاذوب السنديان» التي ضربت الكثير من المناطق اللبنانية لأسباب متعددة، أبرزها انقراض الاأداء الطبيعيين لهذه الدودة، ولا سيما الطيور. وإهمال تقييم الأثر البيئي الخطير لإنشاء السدود السطحية وعدم النجاح في إيجاد استراتيجية شاملة لإدارة النفايات على أنواعها، خصوصا السائلة منها الملوّثة للبر والبحر والأنهُر والوديان بينهما.
صحيح أن المحميات، كان يمكن أن تشكل عنصراً مهماً من عناصر السياحة البديلة، إذا أضيف إليها سنّ القوانين والخطط اللازمة لتنظيمها وتنظيم الزراعات البعلية والبيولوجية الخالية من الكيميائيات، وتشجيع ودعم الأشغال والأعمال الحرفية الصغيرة، وفتح بيوت الأهالي للضيافة واستقبال السياح، المنظمة والمراقبة… إلا أن أحداً لم يهتم بتنظيم هذه السياحة البيئية والاجتماعية البديلة التي تربط أكثر من قطاع وتتوزع عائداتها على المجتمع بأسره، بعد أن كانت مقتصرة على أصحاب الفنادق والملاهي والمسابح السياحية التقليدية المكلفة والمستهلكة للمياه والطاقة والمتسبّبة بمزيد من التلوث وإنتاج النفايات على أنواعها.
مرّ أكثر من ربع قرن على الأفكار المجدّدة والمطوّرة لمفهوم الحماية والمحميات الذي نشأ مع إنشاء وزارة البيئة بداية التسعينيات، مع العلم أن الأموال التي منحتها بعض الجهات الدولية لإنشاء المحميات حول العالم كانت سبباً رئيسياً لإنشاء وزارة للبيئة في لبنان! إلا أن أحداً لم يتلقّف تلك التطورات في مقاربة مفهوم الحماية، وكيفية إعادة دمج النظم الاجتماعية بالنظم الإيكولوجية، بدل عزل الناس عن الأماكن المحمية. ويعود السبب في ذلك، إلى سيطرة المستثمرين على وزارات الدولة وإداراتها، بما في ذلك وزارة البيئة. وهذه إحدى أكبر المآسي الحقيقية لبلد كلبنان، لديه إمكانات طبيعية مميزة، بالنسبة إلى دول المنطقة، لم يعرف كيف يستفيد منها في إنشاء اقتصاد أخضر متكامل يمكن أن يؤمّن عائدات متواضعة للناس وسبل الحماية والاستدامة لهذه الموارد في آن.
الاخبار