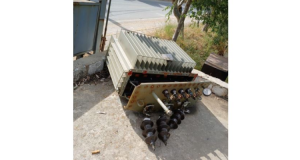مجلة وفاء wafaamagazine
أوّلاً – في السيرة
تأبى السيرةُ الذاتية مشاركتَها في روايتها التي غالباً ما تأتي متماهيةً بها. وإذ كان هذا دأبها، فإنها هكذا تتمرّد على منطق التاريخ ومعنى شموليته الذي، بتأبّيه التوقُّفَ عن ذِكر التفاصيل من الوقائع (والبعضُ يقول: بترفُّعه عنها!) وعلى ما يُترَك في حيِّز المُضمَر والمستبطَن برسم التأويل، تصبح روايةُ السيرة وحدها مادَّةً لصورة، أو لوفرٍ من الصوَر والتصوُّرات الكبرى والمشاريع التي لا تنبني في الوعي من غير مادَّتها المتلازمةِ بها على الدوام. ذاك أنَّ بولس الخوري الذي غادرَنا أخيراً عن عمر ناهزَ المئة، يمكن استجلاء فرادتِه الثقافية من أفكارٍ له تنتمي إلى سجلّ الأحوال الحضارية للمعارف الحداثوية المحرِّرة. إلا أنها، مع ذلك، لم تجد لها في ثقافتنا الموروثة، المتجذِّرة على ترهُّل لدى حرَّاسها، ما يناسب مقامَها السنيّ اللائق فعلاً بموقعها فيه.
كان مولدُه غداة «الحرب الكبرى» التي عُرفت في ما بعد بـ «الحرب العالمية الأولى»، عام 1921، في قرية صغيرة في جنوب لبنان (قضاء صور)، في عائلة مسيحيّة متديّنة. والده كان كاهن القرية ومحيطها، يخدم رعيَّته ويعلّم أولادها. في سن العاشرة، أَرسل الوالدُ بولس إلى «مدرسة القديسة حنّة» في القدس المُعدّة لتنشئة أكليروس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في العلوم الدينيّة، والوضعيَّة أيضاً، مع تدريس الآداب والفلسفة واللغات التي حصَّلَ منها اثنتين قديمتَين: اليونانية واللاتينية، وأربعاً حديثة، هي: الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنكليزية، أتقنَها كلها بالإضافة إلى اللغة العربية، على يد أساتذة رهبان أوروبيين عُرفوا «بالآباء البِيض». مكثَ في مدرسة القدس أربعة عشر عاماً (1931-1944). وبعد تخرُّجه منها، مارس التدريس في المدارس الثانوية. وسيمَ كاهناً في أبرشية صور. وبعدما نال الإجازة في الفلسفة من معهد الآداب في بيروت، التابع لجامعة ليون الفرنسية، باشر تدريس الفلسفة في الثانويات، كما باشر بزياراتٍ لجامعات أوروبية في إيطاليا وفرنسا وهولندا تمهيداً لأطروحة شهادة الدكتوراه في الفلسفة التي سيُعِدُّها والتي ناقشَها تالياً في جامعة لايدن في أمستردام عام 1965، وكانت تحقيقَ مخطوطةٍ عن لاهوتيٍّ من القرن الثاني عشر م. يُدعى بولس الأنطاكي وهو من أحبار الكنيسة الشرقية.
وبعد نيله الدكتوراه، بدأت حياتُه الفكرية والتأليفية تتعمّق في البحث والكتابة بموازاة التعليم العالي، إلى أن بدأت ترسو في ذهنه فكرة «الأنثروبولوجيا الفلسفية» التي كان الفيلسوف الألمانيّ كانط أولَ من أطلقَها، والتي ترى الكائنَ الإنساني محدوداً في التاريخ والواقع، ولكنه يرنو بفطرته إلى أبعد من واقعه، إلى المطلق، رغم عدم إمكاناته المعرفية لهذه الرحلة. واكتشف بولس من ذلك التاريخ الباكر أنَّ الأديان ليست سوى جسور عبور بلغاتٍ وأدواتِ تعبير ثقافية مختلفة تنشد كلُّها هذا المطلق. هذه الفكرة ستبقى معه طيلة عمره، علامةً على فلسفته لا يني يُغنيها ببحوث وخبرات حياتية لا تتوقَّف. ولكنَّ أطروحته هذه كان لها عنده نقيضةٌ فكريةٌ هي «فلسفة الخيبة» التي كان يريد أن تكون هي موضوعَ أطروحته الجامعية، ولكنّه تراجعَ عنها بناءً لنصيحة بعض المُشرفين على عمله البحثي. بهذا، تيَقَّنَ أنه أصبح بعيداً عن التزامه الكهنوتيّ المسيحيّ. أحدُ تلاميذه، وهو الدكتور مشير عون، يقول عنه إنه «انتقلَ من طور الترهُّب الكهنوتي إلى طور الترهُّب الفلسفي». إلّا أنَّ بولس لم يتراجع عن مضمون الخيبة وفلسفتها، إذ عاد ونشرَها في كتابٍ (بالفرنسية) بعد ثلاثين سنة، عام 1996 في بيروت، وبعد عشر سنوات، عام 2007، أعاد نشْرَها في باريس وغدا هذا الكتاب من أبرز مؤلفاته، وهو بعنوان: Le Fait et le Sens, Esquisse d’une Philosophie de la Déception أي «الواقعة والمعنى: مخطَّط في فلسفة الخيبة».
بعد رجوعه من أوروبا إلى لبنان، درَّس «الأنثروبولوجيا الفلسفية» في «جامعة الروح القدس (الكسليك)»، ويتضمَّن مقرَّرُه التدريسي فصلاً مهمّاً عن أصول الفكر الديني. ويبدو أنَّ موقفه الفكريّ من هذا الموضوع حال دون تجديدِ عَقد التدريس معه! فانسحبَ بهدوءٍ، وتابعَ تدريسَ الفلسفة في المدارس الثانوية ذات المناهج الرسمية المُعدَّة سلفاً.
حادثةٌ أخرى حصلت له عندما اتَّصل به صديقُه المطران غريغوار حدّاد من أجل تثقيف الشباب بنشرةٍ دورية: فكانت مجلَّةُ «آفاق» التي حملت أفكارَه، وأسّست لها لفيفاً كانوا يرومون تجديدَ الفكر الديني في المجتمع اللبناني والعربي. فاستثارت بعضَ أبناء الطائفة الآخرين ضدَّ مشروع المجلّة ومآربها. وكانت من نتائجِها أزمةٌ كبيرة أدَّت إلى استقالة المطران حدّاد. وأُوقفت «المجلةُ» وحركتُها الإصلاحية.
وكانت الحرب اللبنانية في بدايتها، عام 1975، عندما رغبَ بعضُ أصدقائه في تدريسه الفلسفةَ في الجامعة اللبنانية. ولكنّ هذه الرغبة أُحبطت أيضاً من بعض أهل الجامعة في كلا الفرعَين (الأول والثاني) من كلية الآداب فيها، بسبب عدم انتمائه إلى القوى السياسية في كلا الفرعَين.
لذلك قرَّرَ أن يقبل، في عام 1977، المنحةَ البحثية الأكاديمية من «جامعة مونستر» (Münster) في ألمانيا، التي استحصل له عليها شقيقُه العلَّامةُ في تاريخ العلاقات بين الديانتَين الإسلام والمسيحيّة، والأستاذ المعروف في ألمانيا، عادل تيودور خوري في الجامعة لمدّة خمس سنوات. وهكذا غادرَ لبنان إلى مونستر. وكانت لبولس فترة مثمرة جداً من الأبحاث حول العلاقات الثقافية الإسلامية المسيحية، من خلال دراسته الفكر العربي المعاصر في عشرات، بل مئات، الأبحاث حول كل الإنجازات الفكرية العربية المنشورة في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وكانت حصيلته منها عملاً في خمسة مجلَّدات…
تأثَّر بثلاثية كانط الذي كان أوّل من وضَع مصطلح «الأنثروبولوجيا الفلسفية»
عاد إلى لبنان عام 1984، في عزّ الحرب، ليعلِّم الفلسفة في «معهد القديس بولس» (حريصا – كسروان). وكانت «صومعتُه» (مسكنُه المؤلَّف من غرفة واحدة) في «البيّاضة»، في منطقة المتن الأوسط، مزاراً من طلاب العلم لناسكها الذي يبدو أن مرحلة ما بعد الحرب أَنست كثيراً من العداء نحوه: فدعته «جامعةُ القديس يوسف» (بيروت) لإلقاء محاضرة فيها عن الإسلام والمسيحية من منظور بولس الأنطاكي. وكان له تكريمٌ في «الحركة الثقافية – انطلياس»، عام 1991، كواحدٍ من «أعلام الثقافة في لبنان والعالم العربي». و«الجامعة الأنطونية» (بعبدا) التي تقوم بتكريم شخصية فكرية مرموقة كل سنة، تحت عنوان «إسمٌ عَلَم»، اختارت بولس الخوري للتكريم عام 2010 في احتفال خطابي لائق، مع إصدار كتاب بوقائع المناسبة. وعندما أزمعت الدولةُ الفرنسية أن تحتفل بالذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية، عام 1989، قامت «الحركة الثقافية – انطلياس»، بمساعدة بعض أعضائها المهاجرين إلى فرنسا، بعقد مؤتمر دراسات دولي عربي/ فرنسي في «معهد العالم العربي» (IMA) في باريس، بعنوان: «الثورة الفرنسية ورحلتها إلى الشرق». ووفدُ «الحركة» الذي سافرَ من لبنان للمشاركة في هذا المؤتمر ولحضور الأنشطة المرافقة له، ضَمَّ: بولس الخوري، ناصر الجميّل، عصام خليفة، أنطوان سيف (رئيس الوفد)… وشارك فيه عشرات من لبنانيّين وعرب موجودين في أوروبا عموماً، وباريس بشكل خاص، وغيرهم… وكان لبنانُ غير الرسمي، ممثَّلاً «بالحركة»، البلدَ الوحيدَ في العالم الذي شاركَ بفاعلية لافتة في هذا الحدث (وخلال الحرب فيه!) بما يليق بالمناسبة التاريخية الكبرى واحتفالاتها في فرنسا! وبالإضافة إلى كل ذلك، كانت «الحركة» تدعوه إلى خلواتها الفكريّة السنوية للقاءاتٍ مع أعضائها، موضوعُها الأساسي تقييمُ دور «الحركة» الثقافي والوطني وعقد جلسات حوار ونقاش حول هذا الموضوع، وتقديم مقترحات بأنشطة لبرنامجها السنوي المقبل. وكان ذلك يتمُّ أيضاً مع مجموعة من المثقَّفين المتنوِّعي الاختصاصات والمواقف الفكرية، أمثال: وضّاح شرارة، وناصيف نصّار، وأحمد بيضون، وسليم نصر وغيرهم…
وخلال السنوات العشر الأخيرة، أخلى بولس التسعيني «صومعتَه» وانتقلَ إلى «بيت الراحة» بعناية جمعيّة «رسالة حياة» التي استودعَها مكتبتَه العامرة بالمؤلفات والمخطوطات، والتي لم يلبث أن تحوّل «البيتُ»، هو بدوره، إلى محجّ ولقاءات حوله في بعض المناسبات، بقدر ما تسمح ظروف النزلاء الآخرين من المعمّرين. أسلمَ فيه الروح، وهو بكامل قواه العقلية، يوم الأربعاء 24/11/2021، عن مئةِ عام وشهرين!
ثانياً – فكره الفلسَفي
عنوانُ أحد أواخر كتبه: «في الدين: مقاربة أنثروبولوجية»، ينطوي على المصطلحات المركزية الدالّة على فلسفة بولس الخوري، بمعنى يمكن معه اعتبار هذا المركز محوراً لكل أفكاره ومفاهيمه: الدين والأنثروبولوجيا، المضمونُ الأساسي ومنهجُه السديد، الحقيقةُ ومتفرّعاتُها… ويعترف بأنه حصرَ معالجتَه بثلاثة ميادين، هي: الفلسفة والإسلام والمسيحية والعالم العربي. في كتاب سابق، حدَّدَ المقاصد والمرادفات هكذا: الدِّين هو «واقعة» و«معنى». «الواقعةُ» هي التعاليم المتوارثة، العبادات (أي الثيولوجيا) والعادات (أي الطقوس)، ويفلت منها جميعها «المعنى»، وهو «المطلق»، أي الحقيقة الدينية الشاملة كل البشر، والباقي في الديانات هو «وقائع» ثقافية متعدّدة، متباعدة الخبرات واللغات والعادات والتقاليد، التي تطمس «المعنى». فالإنسان يتوق إلى المطلق في أيّ زمان وأيّ مكان، ولكنه لا يصل إليه. و«المعنى» أَطلقت الديانات عليه تسميات عدة، إحداها هي «الله». والتسميةُ هي فعلٌ ثقافي. وأداة التمييز الصالحة بين الواقعة والمعنى هي: منهج «الأنثروبولوجيا الفلسفية»، التي تعيِّن بالضبط إمكانات الإنسان المعرفية والمسلكية، أي: ماذا يمكنني، ككائنٍ بشري، أنْ أَعرف؟ وماذا يمكنني أن أفعل؟ وماذا يمكنني أن آمل؟ لقد تأثَّر بولس الخوري بثلاثية كانط الذي كان أوّل من وضَع مصطلح «الأنثروبولوجيا الفلسفية» قيد التداول، معتبراً أنَّ الدِّين هو في حدود العقل، وأنَّ الميتافيزيقيا هي تجاوُز لحدود العقل وإمكاناته الإنسانية المعرفية… وهكذا يكون الإنسان (الأنثروبو) هو مركزَ كل شيء. لكن، جواباً على السؤال الرابع الذي ألحقه كانط بأسئلته الثلاثة الشهيرة، وهو: «ما الإنسان؟». وبعدما دعا إلى «إنسانية الإنسان» (وله كتاب بهذا العنوان)، قال بولس في آخر كتابه المذكور أعلاه: «…إنَّ الإنسان لغز يستعصي حلُّه على الإنسان نفسه» (ص 149)! وقدَّمَ لهذه الأسئلة الكبرى واحدةً من ثلاث إجابات ممكنة، أو ثلاثة مذاهب فلسفية، وهي: الماورائية، والوضعية، والظواهرية. كل واحد من هذه الأجوبة يستأثر بشرعيته المعرفية الإبستمولوجية الخاصة به! أتكون بذلك «فلسفةُ الخيبة» المعلَنة عنده قد باتت «فلسفةَ الحَيرة»؟ أو ربما باتت أحدَ أسمائها الجديدة؟
لقد اقتنعَ بولس الخوري بأنَّ الأنثروبولوجيا تشمل كلَّ البشر، كلَّ ما هو إنساني، بينما الثيولوجيا الدينيّة، أيُّ ثيولوجيا، محصورةٌ بمجموعةٍ قليلة من البشر لهم نمطُ حياتهم الخاصة (أي ثقافتهم) ولا تنسحب على كل إنسان. هنا بدأت رحلة بولس الخوري القاسية مع السلطات الدينية، المسيحية والإسلامية، وغيرها… لا مؤشِّر بأنه تراجَعَ عمّا يعتقده، حتى عامِه المئة. مركزيةُ الإنسان بدل مركزية الله، أو ما نسمّيه الله، كلٌّ بحسب لغته. وبهذا لم يكن مقبولاً. فالله، أو «المُطلق» كما سمَّاه، الذي يتوق إليه كل إنسان، هو غير الله الذي تقول به السلطات، وتعلِّمه، وتعاقبُ مَن يشذُّ عن تعاليمها. الله عند بولس الخوري هو «معنى» الوجود، و«المعنى» لا يدركه إلاّ الإنسان، لأنّه من صنع الإنسان. في هذا التصُّور نجد أفكاراً قديمة: «الكائن الإنساني لا يُدرك إلا ما كان في عالمه ومن عالمه»، يقول. وهو ما يقول به، من المُحدَثين، هايدغر. وتأثر بولس أيضاً بفويرباخ الذي أنسَنَ تعاليم الدين، بقوله: «الجوهر الحقيقي للدين ليس لاهوتياً بل هو أنثروبولوجي»، أي لا يخصُّ الله بل يخص الإنسان. كما نجد عنده أيضاً أثرَ مُطلقِ هيغل التاريخي العقلاني، أي الإنسان بامتياز… مثل هذه الأفكار لم تسمعها الأذنُ الشرقية، بمسلميها ومسيحيّيها، ولا النقاش العلني حولها، حتى ولو كان النقاش رصيناً يقع في خانة الإيمان والاختلاف حول مضمون هذا الإيمان. وربّما قرأوا، وباللغة العربية، هذه الآراء عند شيلينغ وهيغل… وذلك على سبيل الفضول المعرفي، الفلسفي تحديداً، ولكن ليس كموقفٍ علنيّ إيمانيّ ومن شرقيين! وبولس الخوري دعا العالم العربي، بمسلميه ومسيحيّيه وسواهم، إلى أن يجرؤ على الحوار الحرّ في هذه الأفكار الدينية التي بنَت، برأيه، صروحَ الحداثة في الغرب وتفوُّقَه.
وإذا عُدنا إلى عنوان الكتاب أعلاه، نجد أنه فسَّرَ استعماله مصطلح «مقاربة» بأنَّ الإنسان، برأيه، لا يمكنه امتلاك الحقيقة، فالمقاربة توضح هذا المقصد.
مهما يكن، ومن ناحية نقدية، فالأنثروبولوجيا المعاصرة لم تعد فلسفية، بل قامت أصلاً كأحد العلوم الإنسانية لأنها طردت منها الفلسفة، وهذا بحث طويل لا مكان له في هذه الفسحة. ومن شاء التوسُّع فيه، فله مرجعٌ بذلك تحديداً، كتاب أبحاث حول المؤلِّف بعنوان: «بولس الخوري: فيلسوف اللاكمال» (منشورات الجامعة الأنطونية، بعبدا، لبنان)…
لبولس الخوري صفات شخصية تؤطّر أفكاره الفلسفية. ذو منحى إنساني لطيف، نوراني، يتَّسم بالهدوء والحياء، وبذكاء ثاقب لا يستعمله للعنف أو لإذلال الضعفاء. ومع ذلك، هو ناصع عنيد لا يساوم على ما يعتبره حقيقة. وكمعلّمٍ، كان يجترح السؤالَ الفلسفي بلغةٍ يحرص على وضوحها وعلى أن تكون رسالةً قابلة للوصول، والاقناع. بريء بطروحاته وجرأته، لا بل من أجرأ ما عرف العالم العربي من أفكار في الدين والتديُّن، ومن غير أن يعادي المتديِّنين الآخرين غيره! لا يهاب المواجهات العدائية. يتصدّى لها بوداعته، وغالباً بصمته الموقَّت. عميق الفكر في المسائل التي استلَّها من عصره ومن بيئته الثقافية اللبنانية والعربية بمعتقداتها الدينيَّة على الخصوص ومكانتها: بواقعها وطموحاتها الملجومة. واسع الثقافة الفلسفية، وسَّع آفاقها بمؤلَّفاته العديدة المميَّزة بجدَّتها وغناها وعمقها وبإثارتها للجدل الواسع حول مقارباتها. مثال الحكيم الهادئ المتبصِّر والمتواضع. متنسّكٌ للبحث والكشف حتى آخر لحظة من عمره المديد، لذا أثرُه الطيّب باقٍ.
الاخبار